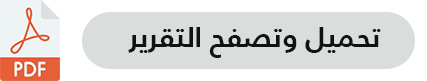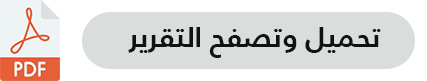
مقدمة
في تحوُّلات ذات دلالة جديرة بالمتابعة، بدأت موجةٌ من المراجعات والتوجُّهات الفكرية في عددٍ من بلدان منطقة الشرق الأوسط، بما يُنبِئ بتغيير في المشهد القائم، ففي يوليو الماضي، أطاح الرئيس قيس سعيد بحركة النهضة التونسية من البرلمان والحكومة، وفي سبتمبر خسر حزب العدالة والتنمية في المغرب الانتخابات البرلمانية خسارةً كبيرة وحاسمة، ودالَّة على رسائل متعدِّدة أراد الشعب المغربي إيصالها، وفي سبتمبر أيضًا استقال عددٌ من القادة التاريخيين والمؤسِّسين لحركة النهضة التونسية، واتّهموا في بيان لهم الحركة بالاستبداد الداخلي، وانفراد مجموعة من أصحاب المصالح بالرأي والقرار.
وفي أكتوبر، اشتعل الخلاف والصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وانقلب جناح إبراهيم منير (القائم بأعمال المرشد) على حليفه الإستراتيجي جناح محمود حسين (أمين عام الجماعة)، ولا تزال الاشتباكات بين الجانبين مستمِرَّة ومشتعِلة، ويسعى كُلّ فريق للإمساك بزمام الجماعة ومواردها المالية والإدارية.
في تلك الأثناء، وفي منتصف أكتوبر، جاءت نتيجة الانتخابات العراقية في بغداد، بفوز التيّار الصدري وبعض القوى العُروبية والمدنية، مقابل خسارة قاسية لوُكلاء إيران من الفصائل السياسية وأذرُعها المسلَّحة. وتبِع ذلك انقساماتٌ في البيت الشيعي، ورفض لنتائج الانتخابات من قِبَل «الإسلاميين الشيعة» الموالين لإيران، مهدِّدين باستعمال العُنف إذا لم تتغيَّر نتائج الانتخابات.
ليس بعيدًا في أفغانستان، حيث تتراجع حركة «طالبان» عن ميراثها العنيف، في إيماءة إلى فشل النموذج القديم «المتشدِّد»، أظهر النهج الجديد للحركة وخطاباتها التي تسعى من خلالها إلى استقاء شرعية دولية ولغة للتسامُح، والوعود بدولة تراعي النُظُم والقوانين الدولية، واشتباكها مع مايعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أظهر كُلّ ذلك تحوُّلًا عن النزعة القديمة «المتشدِّدة» الرافضة للمقاربات الحداثية، التي لا تتّفِق مع الفكر التقليدي والمحافظ لمنظِّري «طالبان» والرموز الدينية المرتبطة بمنهجها القديم، وبناءً على تجربة غير ناجحة لصيغتهم في الُحكم (1996-2001م). ولا شكَّ أنَّه لا يمكن الجزم بجدِّية ومصداقية مراجعات «طالبان»، وهل هي مراجعات إستراتيجية على مستوى الأفكار والفلسفات والفقهيات، أم هي مراجعات براجماتية بُغية تعزيز الشرعية داخليًا وخارجيًا. لكن في كُلّ الأحوال، فإنَّ الجيل الجديد لـ «طالبان» سيتجاوز كثيرًا من الإرث الطالباني القديم.
أولًا: ما بعد «الإسلام السياسي»
هذه الخارطة في الشهرين الأخيرين فقط، كفيلة بالتأمُّل الشديد في سؤال عن مرحلة ما بعد الإسلاميين، ولا سيّما إذا أضفنا إليها الخسارات المتتالية للإسلاميين، وفقدانهم مواقعهم التي وصلوا إليها، أو أمِلوا في الوصول إليها منذ 2011م وحتَّى الآن. فهل يُمكن القول إنَّنا في مرحلة ما بعد الإسلاميين السُنَّة والشيعة على السواء؟ وهل تلك الخسائر المتتالية هي نتيجة مجرَّد حملات إعلامية ضدّهم، أم هي إخفاق وفشل حقيقي في إدارة الشأن العام؟
الحقيقة أنَّه وبغضّ النظر عن أسباب هذه الخسائر المتتالية، فإنَّها دالَّةٌ جدًّا، على عدم مركزية الإسلاميين في منطقة الشرق الأوسط كما ظنَّت وردَّدت بعض الدوائر البحثية في السابق؛ لأنَّه سُرعان ما مَجَّ الناس الإسلاميين بمجرَّد وصولهم إلى السُلطة، وإدارتهم للشأن العام، واختبار قدُراتهم السياسية بالممارسة العملية.
أدرك الناس أنَّ الخطاب الذي تتبنَّاه تلك الجماعات بمصلحة وتفرَّد، ليس له صدى على أرض الواقع، وليس من أولوياتهم العملية، وأنَّ ثمَّة فجوة كبيرة بين التنظير والممارسة. فرأوهم في الحُكم مستبِدِّين وإقصائيين، إضافة إلى فشلهم في إصلاح الوضع الاجتماعي، وتحسين أوضاع الناس الاقتصادية، والعمل في ملفَّات الصحَّة والتعليم، وتقليل نسب الفقر والبطالة، وتعزيز الحرِّيات المدنية والسياسية.
كانت مرحلة تصدُّر الإسلاميين للواقع وإدارتهم للشأن العام، مهمَّة لتعريف الناس بمشاريعهم «المثالية»، التي ارتكزت على تضخيم عيوب الدولة الوطنية القائمة، وإشاعة نماذج تاريخية للعامَّة تدغدغ عواطفهم، وتُثوِّر نفوسهم، لكن سرعان ما اصطدم الناس بواقع مؤلم.
واعتقد الإسلاميون أنَّ عقْدنة السياسة، وتديين الشأن العام، كفيل ببقائهم أطول فترة ممكنة في سَدَّة الحُكم، أو في موقع الشرعية والمقبولية لدى الجماهير، باعتبار احتكارهم للقراءة الدينية، بيد أنَّ هذا كان سببًا من الأسباب الرئيسة لخروج الناس عليهم، ونبْذهم لمشروعهم.
الأمر المركزي الآخر، أنَّ الإسلاميين أصلًا، بمختلف تيَّاراتهم، لا يؤمنون بالفقه الدستوري والدولة المدنية، فالإسلاميون الشيعة -خاصَّةً الولائيون- يؤمنون بولاية الفقيه المُطلَقة، وشموليتها جغرافيًا ومذهبيًا، وبالتالي نبْذ الديمقراطية والسيادة الشعبية. لذا خرج المتحدِّث باسم «كتائب حزب الله» ليُشكِّك في نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، ويُهدِّد ويتوعَّد، وخرج آخرون من فصائل وأحزاب «ولائية» يسردون نفس السردية. وليس هذا بمُستغرَب عليهم، ذلك أنَّ «الولائيين» يعتقدون أنَّ الولاية لا تكون إلا بالتنصيب «الإلهي»، لا بالانتخاب، وبالتعيين لا بالاختيار، في تماهٍ واضح مع نظرية الإمامة في حضور «الإمام المعصوم» نفسه، أي أنَّهم تعاملوا في فترة غياب «المعصوم» بنفس منطق «حضوره». وفي إيران تعتقد النُّخبة الدينية الحاكمة أنَّ الانتخابات من باب السياسة والبراجماتية؛ لرفع الحرج عن النظام، وبالتالي فهي تشريفية، أكثر منها حقيقية.
أمَّا الإسلاميون السُنَّة، فغالبيتهم كذلك لا يؤمنون بالدولة الدستورية والمدنية، وثمَّة نص شهير للشيخ محمد الغزالي ينتقد فيه جماعة الإخوان المسلمين؛ بسبب موقفهم من دستور 1923م في مصر، وانقلابهم عليه، إضافة إلى كلمات لرموز ومنظِّرين إسلاميين، ينتقدون فيها الديمقراطية والدساتير، كالبنّا والهضيبي وقطب، باعتبار تلك الدساتير عُمْلة غربية، وبِدعة لا يجوز العمل بها، أو الاحتكام إليها، وثمَّة كلمة شهيرة لحسن البنّا يصف فيها بعض المنشقِّين عن الجماعة بــــ «الخوارج».
فمشاركة الإسلاميين إذن في الانتخابات، هي من باب تحسين صورتهم أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وهي في نفس الوقت محاولة للوصول إلى السُلطة بطريقة مُتاحة، في حال افتقاد القُدرة على الإمساك بالسُلطة والانفراد بها بطُرُق أُخرى، بسبب قوَّة الفاعلين الآخرين، أو إكراهات سياسية واجتماعية.
ثانيًا: البحث عن شرعية
يحاول كثير من الإسلاميين السُنَّة والشيعة تخليق جذور علمية ومنهجية لهم في التراث الإسلامي، فينسبون أنفسهم تارةً إلى مدارس فقهية، وتارةً أخرى إلى مدارس فلسفية، من أجل تمرير مقولاتهم، وتعزيز شرعيتهم. لذا؛ فإنَّ المقارنة بين «إصلاحية» جمال الدين الأفغاني وعبده ورشيد رضا، على المستوى السُنِّي، أو الميرزا الشيرازي، والنائيني، وفُقهاء الدستورية، على المستوى الشيعي، المقارنة بين هاتين «الإصلاحيتين» وبين الإسلاميين الشيعة والسُنَّة اليوم، في غير محلِّها؛ لأنَّنا ندرك من خلالها الفجوة الكبيرة بين الفريقين.
فالأفغاني ومدرسته تناغموا مع الحداثة، ونشدوا صهر الإسلام في الديمقراطية والعالم الحديث، مع حفظ الثوابت والأُصول والقطعيات، التي لا يمكن تجاوُزها، وكان هذا هدفهم الرئيس، والمتن الذي يدورون حوله. في حين أنَّ الإسلاميين المعاصرين، إمَّا أنَّهم مناهضون للحداثة بالعُنف والعسْكرة وملْشنة السياسة فضلًا عن عقْدنتها، وإمَّا مناهضون لها سياسيًا، فيُشاركون في الانتخابات من أجل تطبيق مشاريعهم المناقضة للحداثة، والدولة الوطنية، والديمقراطية. إضافة إلى صناعة الاستقطاب المجتمعي طائفيًا أو أيديولوجيًا، تلك الاستقطابات التي تتحوَّل إلى صراعات مميتة لأيّ محاولات جادَّة نحو إصلاح سياسي ودستوري، على نحو ما استقرأ الفقيه الدستوري طارق البشري. وإذا كان فريق من الإسلاميين الشيعة اليوم يعارض الانتخابات وينقلب عليها، ويخاصم الدولة الدستورية، فإنَّ الآخوند الخراساني وفُقهاء الدستورية كانوا على النقيض من ذلك، وكان كفاحهم السياسي كُلّه في سبيل تعزيز الديمقراطية، والحلم بدولة دستورية مدنية. وإذا كان فريق آخر منهم يؤمن بالولاية المُطلَقة للفقيه، فإنَّ هذا أيضًا لم يكُن منهج فُقهاء الدستورية ولا المستبدَّة، وليس له ما يدعمه في التراث نظريًا وعمليًا.
وراهن كثير من المفكِّرين على أنَّ الانتخابات المتتالية رُبَّما تُحدِث تغييرات جوهرية في أنماط الإسلاميين المعاصرين، على مستوى الأفكار والبُنى الإستراتيجية، لكن حتَّى الآن فإنَّ مشاركتهم في الانتخابات لم تُحدِث تحوُّلات ديمقراطية حقيقية في الداخل واللُّبّ، بل إنَّ الاستقالات والانشقاقات التي تحدُث في الحركة الإسلامية باختلاف مسمَّياتها وصيغها، تعتمد في الأساس على تغوُّل الاستبداد الداخلي وتهميش الشورى والديمقراطية، وتمتين الاستبداد وفقه الطاعة.
لذا فإنَّنا أمام سيناريوهين: إمَّا أن تحدُث تحوُّلات إصلاحية وليبرالية في بِنية تلك الحركات، مع الأجيال التالية للمؤسِّسين بفعل إكراهات الواقع السياسي والاجتماعي وضغوط الدولة الحديثة، وإمَّا أن تبقى تلك الحركات في حالة تكلُّس فكري وسياسي، حتى تُتجاوَز كُلِّيًا أو جزئيًا مع الزمن وعامل الوقت، وبروز حركات أُخرى ألْصَق بمطالب الناس وتوجُّهاتهم.
وفي كُلّ الأحوال، فإنَّ الجماهير والأجيال الجديدة في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا باتت أكثر نقدًا، وأقلّ تقبُّلًا لفقه الطاعة العمياء، الذي تفرضها تلك الجماعات، حتَّى من داخل تلك التيّارات نفسها. وبالتالي، فإنَّ الضغوط الاجتماعية والأزمات السياسية التي يواجهها الإسلاميون اليوم من الرباط إلى بغداد، إلى كابل، مرورًا بتونس والجزائر وطرابلس والخرطوم والقاهرة، تبدو مختلفة تمامًا عمَّا تعرَّضت له تلك الحركات في الماضي.
في المقابل، هناك إرادة جادَّة من دول عربية مركزية، كدول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لتمتين الدولة الوطنية الحديثة، ذات السيادة والحكومة المركزية القويَّة، وإعلاء شأن القانون، والعدالة، ورفع مستويات المعيشة، وإحداث تحوُّلات حقيقية في مفاصل الاقتصاد والبُنى التحتية، والاشتباك مع الأفكار المتطرِّفة وجماعات ما دون الدولة. وفي النهاية، فإنَّ هذا النموذج قادر (بما يملك من مشروع حداثي وقِيَمي) على مواجهة إيران وكبحها، وقادر كذلك على إضعاف الإسلام السياسي، وتهميشه ما لم يعدِّل من سلوكه، ويحدث مراجعات جذرية في أفكاره وفلسفاته وتصوُّراته.
خُلاصة
يبدو الإسلام السياسي اليوم في مأزق كبير، ليس على المستوى السياسي فقط، ولا على مستوى الخسائر التي مُنِي بها في السنين الأخيرة منذ يناير 2011م وحتَّى اليوم، بل تبدو أزمته الكبرى في استبداد داخلي انتشر في مفاصل تيّاراته، وعدم قُدرتها على صناعة مراجعات فكرية وفلسفية تمكِّنها من مصالحة الشعوب والأنظمة، والاستمرار كفاعل مدني في المشهد الديني والسياسي، بعيدًا عن فقه المواجهة والتمايُز، وتجهيل المجتمعات، وتكفيرها، والخروج على أنظمتها. وتبدو هذه الأزمة التي يمُرّ بها الإسلام السياسي مفصلية وحاسمة في تاريخ تلك الحركات، بل وتاريخ المنطقة بأسرها؛ فإنَّ التيّارات والفرق تزول وتذهب، كما تذهب الدول ويفنى الأشخاص. ونظنّ أنَّ تلك الجماعات قد بلغت مرحلة الشيخوخة الفكرية والعمرية، ولا يعني هذا أنَّنا أمام مشهد جديد ينتهي منه وجود الإسلام السياسي في المدى القريب، لكنَّنا أمام مشهد انتهاء فاعلية الإسلام السياسي وأفوله، من جرَّاء فشل وإخفاق لصيق الصِلة ببِنية تلك التيّارات وأفكارها وتأسيسياتها، وليس فقط بسبب سياسة خصومها نحوها كما تُردِّد دومًا.