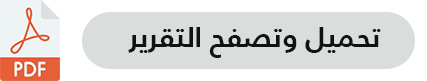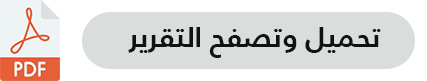
مقدمة
يُنظَر لمشروع «الاستقلال الإستراتيجي»، الذي طرحته فرنسا، من زوايا مختلفة في شتَّى دول الاتحاد الأوروبي، إذ ترى باريس أنَّ هذا المشروع سيُحوِّل الاتحاد الأوروبي من قوَّة اقتصادية إلى لاعب جيوسياسي دولي مستقِلّ عن الولايات المتحدة. وقد حظِيت هذه الفكرة بشعبية في أوروبا، لا سيّما خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (2017م حتَّى بداية 2021م)، حيث لم تكُن التبعية الأوروبية المتنامية لواشنطن في ذلك الحين مرغوبة، بالمقارنة بعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما (2009م-2017م). سيُناقش هذا التقرير حجم العوائق والتحدِّيات التي تقف أمام تحقُّق المشروع، وفُرص نجاح هذا المشروع الفرنسي للوصول إلى أن تكون أوروبا لاعبًا جيوسياسيًا دوليًا مستقِلًّا عن الولايات المتحدة.
أوَّلًا: العوائق والتحدِّيات أمام المشروع
تقف المصالح المتضاربة لدول أوروبا وتركيز كُلّ دولة على علاقاتها الثنائية مع واشنطن عقبةً رئيسةً أمام تحقيق «الاستقلال الإستراتيجي» الأوروبي، كما أنَّ هناك عقبةً أُخرى، وهي أنَّ الاتحاد الأوروبي -في غرضه ومفهومه الأساسي- ليس تكتُّلًا لاستعراض القوَّة، ومن المهم التركيز على هذه الحقيقة عند الحديث عن إنشاء أوروبا قويَّة. بالنسبة لمعظم دول أوروبا، كان إنشاء سوق مشتركة الدافعَ وراء الانضمام للاتحاد الأوروبي، وبدأ هذا المشروع الاقتصادي عام 1957م بإبرام «اتفاقية روما»، التي كانت نواة هذا التكتُّل الاقتصادي الأوروبي، وتجسيدًا لتكامُل السوق الأوروبية المشتركة. ويوضِّح هذا الدافع الاقتصادي أنَّ السبب الذي يمنع الاتحاد الأوروبي من أن يصبح قوَّةً مستقِلَّةً على المسرح الدولي، ليس نقص الإمكانات، بل غياب الإرادة السياسية، إذ لا تُجمِع دولُ الاتحاد الأوروبي على رؤية جيوسياسية واحدة. وتتمثَّل عقبةٌ أُخرى في أنَّ المشروع الفرنسي يقوم على دعم السيادة الأوروبية، بينما تُعَدّ الأطراف الفاعلة الأوروبية الخاصَّة جزءًا من النظام الاقتصادي الدولي القائم على القواعد الأمريكية. وخلال الفترة من 2019م إلى 2020م، دعا الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين لبدء حوار مع روسيا دون مشاورات، مع باقي شرُكاء باريس المهمِّين في الاتحاد الأوروبي، وهذا أحد الأسباب وراء عدم تأييد دول البلطيق أو دول أوروبا الشرقية بصورة خاصَّة للمشروع الفرنسي. ويُضاف إلى ذلك تصريح ماكرون في مقابلة أجرتها معه مجلَّة «إيكونوميست»، بأنَّ «الناتو ميِّتٌ دماغيًا»، وقد أدَّى هذا الانتقاد لـ «الناتو» والتحرُّك الفرنسي أُحادي الجانب نحو روسيا، إلى تقويض مصداقية ماكرون عند غالبية دول أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثمَّ يبدو أنَّ المشروع الفرنسي مكمِّلٌ لحلف شمال الأطلسي، وليس بديلًا عنه. وإن صحَّ القول، فإنَّ الفرنسيين لطالما عدُّوا الاتحاد الأوروبي وسيلةً لمواجهة الولايات المتحدة و«الناتو»، وإنَّ واقعية صُنَّاع القرار في فرنسا جعلتهم يتّخِذون موقفًا براغماتيًا، ويقدِّمون مبادرة مشروع باريس على أنَّها مكمِّلةٌ لـ «الناتو»، وليست منافسةً له. ويؤمن صُنَّاع القرار الفرنسيين بأنَّ هذه البراغماتية، ستُساعدهم في إقناع غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي بأهمِّية مشروع الدفاع الأوروبي.
ومن جانب حلف الناتو، فقد قرَّر 30 من رؤساء الدول الأعضاء فيه -خلال القمَّة الثامنة والعشرين للحلف التي عُقِدت في بروكسل الاثنين 14 يونيو 2021م- تعزيزَ شراكتهم الأمنية، وفتح فصل جديد في تاريخ الحلف. وتتمثَّل الأهداف الثلاثة الرئيسة لحلف الناتو في: الدفاع الجماعي، وإدارة الأزمات، والأمن التعاوني. وتشكِّل أعمال روسيا «العدوانية» أهم خطرٍ يهدِّد تحالُف الدفاع الجماعي، لكن خطر الإرهاب المتنامي بات أولويةً تركِّز عليها أجندة دول حلف الناتو منذ عام 2001م. ثمَّ كشفت قمَّة «الناتو» الثامنة والعشرين لعام 2021 عن تهديد جديد للحلف، يتمثَّل في بروز الصين ونفوذها على الساحة الدولية، وطُرِح هذا التهديد على طاولة النقاش خلال القمَّة، إذ «دعا قادة «الناتو» الصين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتصرُّف بمسؤولية في النظام الدولي، واتّفقوا على الحاجة إلى التصدِّي للتحدِّيات التي يفرضها النفوذ الصيني المتنامي، وسياسات الصين الدولية، وإلى التعامل مع الصين للدفاع عن مصالح الحلف الأمنية».
وكما ذكرت كوري شيك في كتابها «الممرّ الآمن: الانتقال من الهيمنة البريطانية إلى الأمريكية»، فإنَّ التهديد الصيني الجديد للنظام الدولي القائم على القوانين، يبدو مُغايرًا للانتقال السِلْمي من القيادة البريطانية إلى القيادة الأمريكية للعالم، خلال القرن العشرين، وسيكون هذا التحدِّي الصيني الجديد على رأس أجندة دول «الناتو» في المستقبل المنظور؛ لأنَّ الخطر الصيني لا يقتصر على كُلّ دولة في الحلف بصورة منفردة، بل يهدّد الحلف نفسه؛ نظرًا لما حقَّقته الصين من إنجازات في التقنيات العسكرية، وبسبب أنشطتها المتزايدة في المجال السيبراني، وتدخُّلاتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط؛ وبالتالي فرُبَّما يتمثَّل المسار القادم لـ «الناتو» -كحلف عسكري- في منع إنشاء تحالُف مناهض للغرب، ومناهض للهيمنة بين الصين وروسيا وأفغانستان تحت حُكم «طالبان» وإيران.
كما أنَّ النفوذ المتنامي للقُوى غير الغربية، مثل روسيا والصين، يؤثِّر على مستقبل سوريا؛ وبالتالي على «الناتو» -كتحالُف عسكري- أن يضع دراسة الأنشطة الدبلوماسية/العسكرية غير الغربية، التي تهدَّد نفوذ دول الحلف في إدارة الأزمات على رأس أجندته. وستكون العقبة الأهمّ في التصدِّي لصعود هذه القُوى الجديدة الانقسامات بين دول «الناتو»، إذ لا يُجمِعون على ردّ مشترك على التحدِّي الصيني (الذي قد يتضمَّن بعض الدعم من روسيا)، حيث يدور جدلٌ حالي بين مؤيِّدي الحوار والاحتواء الغربيين، ومن يروْن ضرورة ردْع النفوذ الصيني والروسي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. ولا ينبغي على أطراف هذا الجدل إخفاء مصلحتهم المشتركة في الحفاظ على تحالُف عسكري، يقوم على قِيَمٍ ديموقراطية، ومُثُلٍ مشتركة في حقوق الإنسان. ولمواجهة هذه التحدِّيات الجديدة والتحدِّيات القديمة، لابُدّ من إدراك أهمِّية تعزيز العلاقات السياسية، التي تربط التحالُف العسكري (الناتو)، لا سيّما عند التفكير في احتمالية تحوُّل أفغانستان تحت حُكم «طالبان» إلى قاعدة إقليمية للإرهاب الدولي، وإلى دولة موالية للصين، لا سيّما أيضًا عند النظر إلى النفوذ الروسي المتنامي في سوريا، وإلى احتمالية تهميش دول «الناتو» في العملية الدبلوماسية المتعلِّقة بإنهاء الحرب في سوريا (محادثات أستانة). وعلى دول «الناتو» أن تأخُذ في الحُسبان الرابط الجديد بين النزاعات في سوريا ولبنان وجنوب القوقاز (حرب كاراباخ)، وما يحدُث في المسرح الأفغاني/الباكستاني؛ ففي مناطق النزاع تلك يتحرَّك المقاتلون (الميليشيات الشيعية والمرتزقة الأتراك) من معركة إلى أُخرى؛ وبالتالي فعلى «الناتو» إعادة النظر في نهجه الإقليمي تجاه دور الفاعلين العسكريين من غير الدول في الحرب الحديثة، لا سيِّما في أعقاب إضعاف المؤسَّسات الوطنية في بلدان مثل سوريا والعراق وأفغانستان، ونقل وانتشار التقنيات العسكرية الجديدة بين الأطراف الفاعلة من غير الدول المعادية للغرب، مثل حزب الله والميليشيات الشيعية في سوريا والعراق والحوثيين في اليمن و«داعش» و«طالبان» في أفغانستان وباكستان، إذ سهَّل تطوُّر التقنيات العسكرية مثل الطائرات المسيَّرة والصواريخ البالستية كثيرًا على هذه الجماعات، تحسين قُدراتها في المجاليْن الدفاعي والهجومي. ويجب أن يرُدّ «الناتو» على هذه الوقائع الجديدة، وأن يشمل ردّه مسألة الدعم الروسي/الصيني لهذه الجماعات، أو العلاقات معها. أمَّا إيران؛ فالردود غير المتماثلة والأنشطة الهجينة، التي تقوم بها على سبيل المثال، من الأسباب التي تستلزِم ردًّا تقليديًا من «الناتو» عليها، لكن ذلك لم يعُد كافيًا لحماية أمن دول الحلف.
وأمام «الناتو» أيضًا تحدٍّ آخر يكمُن في الانتشار النووي الأُفقي (بين الدول غير النووية)، والعمودي (زيادة ترسانة الدول النووية)، ومن ثمَّ يجب أن ينصَبّ تركيز دول الحلف على الأنشطة النووية الروسية والصينية، وعلى تنقيح إستراتيجية دول «الناتو» الدبلوماسية تجاه الدول، التي قد تصبح نوويةً مستقبلًا، مثل إيران.
ثانيًا: فُرص نجاح المشروع
في ظِلّ هذه الظروف، هل يمكن تحقيق مشروع «الاستقلال الإستراتيجي» الأوروبي، أو إنشاء «ركيزة أوروبية» داخل حلف الناتو؟ هُناك بُعدين يمكن مناقشتهما، وهي أوَّلًا: لا يمكن إغفال مخاوف حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من تركيا، بعد شرائها نظام الصواريخ الروسي إس400، وتدريباتها العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وما إذا كانت ستظَلّ ملتزمةً بآلية فضّ النزاع، التي تهدُف إلى تجنُّب الصدام المباشر بينها وبين اليونان (آلية خطّ الاتصال). وحتَّى في حال ظلَّت تركيا عضوًا ملتزمًا بحلف الناتو، فإن ثمَّة خلافات كبيرة بين أعضاء الحلف. ووفقًا لما ذكره الأمين العام لحلف الناتو، فإنَّ الحلف يملك القُدرة الكاملة على حلّ هذه الخلافات، والتخفيف من مخاطر أيّ حادثة عسكرية تقع شرق البحر المتوسِّط؛ نظرًا للوجود العسكري المكثَّف للقوّات اليونانية والتركية. وعلى الرغم من ذلك، يهدُف التحالُف العسكري اليوناني-الفرنسي لمواجهة التهديد العسكري التُركي الملموس لأثينا مواجهةً مباشرة، وتعكس هذه الشراكة العسكرية الجديدة الإرادة السياسية لعضوي «الناتو» (اليونان وفرنسا)، الهادفة إلى التجهيز لمواجهة عسكرية ضدّ عضو ثالث في الناتو (تركيا).
أمَّا البُعد الثاني الذي يجب تسليط الضوء عليه، فهو أنَّ الدور الأوروبي في الساحة الدولية لا يزال مسألة خلاف في أوروبا، إذ تتّفِق ميركل ودراجي وسانشيز ومورافيكي على أن تعزيز قوَّة أوروبا لا يتنافى مع تعزيز قوَّة حلف الناتو، فيما يرى عديد من قادة أوروبا -بمن فيهم المستشارة الألمانية- أنَّ قوَّة أوروبا الاقتصادية ستُعزِّز قوَّتها السياسية، ولا تقصرها على مشروع الدفاع المشترك. أمَّا دول البلطيق فلا تزال غير مقتنعة بالفكرة الفرنسية، إذ ذكر أحد الدبلوماسيين الفرنسيين أنَّه «بمجرَّد التحدُّث إليهم عن الاستقلال الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي يردِّدون الناتو، الناتو، الناتو». ولم تتأثَّر دول البلطيق حتَّى الآن بتصريحات بايدن، التي يدعو فيها ضمنيًا إلى تعزيز الدفاع الأوروبي، إذ تعُدّ تلك البلدان أيّ تهديد حقيقي أو مُتصوَّر على حلف الناتو مشكلةً وجودية؛ بسبب مجاورة روسيا لها. ومن المرجَّح أن تعكس رؤية الحلف «الورقة البيضاء The White Paper» بشأن الدفاع الأوروبي -التي ستُنشَر في عام 2022م أثناء رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي- طموحَ باريس في «الاستقلال الإستراتيجي». وقبل اعتمادها الرسمي، سيقدِّمها الممثل السامي جوزيب بوريل في منتصف نوفمبر 2021م إلى وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، ثمَّ تناقشها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر. ولن تقضي هذه الورقة على انعدام إجماع دول الاتحاد الأوروبي في مسألة «الاستقلال الإستراتيجي» الأوروبي، وللتغلُّب على الخلافات الداخلية الأوروبية سيتعيَّن على محتوى «الورقة البيضاء» تحديد المصالح الأوروبية المشتركة، لا سيّما فيما يتعلَّق بالتعامُل مع جيران الاتحاد الأوروبي، إذ لا يحظى المقترح الفرنسي -الرامي إلى تحقيق «الاستقلال الإستراتيجي» الأوروبي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة- بالإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وقد أثبت الانسحاب الفوضوي من كابول عجزَ الولايات المتحدة عن التصرُّف باستقلالية. وفي أعقاب اتفاقية أوكوس الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كرَّرت فرنسا التزامها تجاه «الناتو»، لكنَّها وقَّعت عقودًا رئيسيةً مع اليونان بتسليمها فرقاطات وطرادات، بالإضافة إلى طلب حديث لشراء طائرات «رافال» الفرنسية. وتَعُدُّ تركيا الشراكةَ اليونانية-الفرنسية خطرًا يهدِّدها، لا سيّما أنَّ هذه العقود تضمَّنت بندًا للمساعدة المتبادلة. وفي هذا السياق، هل يمكن أن يواجه الجيش التركي المجهَّز بغواصات ألمانية في يومٍ ما، السفن اليونانية، التي باعتها فرنسا لليونان في بحر إيجه؟ وفي النهاية، سيتوقَّف تحقيق «الاستقلال الإستراتيجي» الأوروبي على قُدرة الدبلوماسيين الفرنسيين على إقناع حُلفائهم الأوروبيين بضرورة وجود منظَّمة أوروبية جديدة إلى جانب «الناتو»، وسيعتمد تحقيق المشروع أيضًا على قبول الولايات المتحدة، وقد توافِق عليه إدارةُ الرئيس الأمريكي جو بايدن لدوافع سياسية، لكن من المُرجَّح أن يواجهَ رفضًا من «البنتاغون».